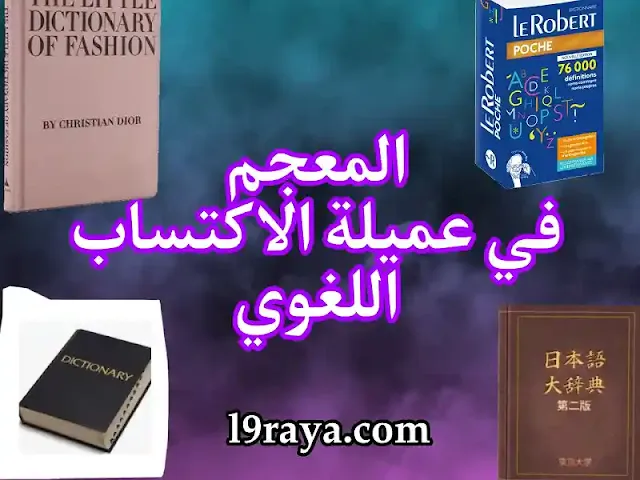المعجم وأثر العوامل الخارجية في عملية الاكتساب اللغوي
تعد اللغة وعاء العلم والثقافة، وأداة
للتواصل بين أفراد المجتمع، تحتجن أنساق التفكير التي تربط الماضي بالحاضر الخاص لمجتمع
معين، فالمتعلم يتأثر بمعجم بيئته ويكون من خلالها معجمه الخاص، فالإنسان "كما
يقول ابن خلدون (ابن بيئته وعوائده، لا ابن فطرته وطبيعته)[1]،
فعملية الاكتساب اللغوي بهذا المعنى تتم في سياق تداخل مجموعة من العوامل التي
تؤثر سلبا على هذه العملية.
المعجم وأثر العوامل الخارجية في عملية الاكتساب اللغوي.
إن المتتبع للمشهد اللغوي بالمغرب يلاحظ الوضع الذي آلت إليه اللغة العربية في ظل غياب إرادة سياسية واضحة تتسم بالعقلنة والواقعية، تعمل على تنظيم الوضع اللغوي من جهة،
وتسطير تخطيط لغوي مصحوب ببرنامج منضبط تعمل الجهات المسؤولة على تنزيله وتفعيله في أرض الواقع، ولعل بعض النماذج التي اعتمدت سياسة لغوية تستثمر في اللغة وتعمل على تطويرها تدفعنا إلى الحديث عنها، إذ إن العامل السياسي يشكل محور تحقيق النهضة لأي لغة، إلى جانب عوامل أخرى كالعامل الديني، والاقتصادي، والمعرفي والإنتاجي...
خاصة في ظل عالم لم يعتمد في اقتصاده على المصادر التقليدية للقوة، وهي: الأرض، واليد العاملة، ورأس المال، بل صار للمعرفة بشتى أنواعها العلمية، والأدبية، والتقنية... دورا أساسا في تنمية الاقتصاد، فاللغة هي الوسيلة التي تخول للإنسان الابتكار والابداع والإنتاج،
وهي ما تجعله قادرا على تحقيق تنمية في مجال عيشه المشترك، لذلك نجد أن العديد من الدول المتقدمة مثل اليابان تولي أهمية بالغة للغة في ميدان التنمية، والجدير بالذكر أن هذا المفهوم الأخير لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل شمل مجالات اجتماعية وثقافية وسياسية،
وهذه الفجوة تتداخل في تعميقها عدة عوامل، منها: العامل السياسي،
والإعلامي، والاقتصادي، والتاريخي...، كل هذه الجوانب تجعل المتعلم لا يتجاوز حدود
البنية السطحية للغة لكي يصل إلى البنية العميقة، مما دفعنا إلى الاعتماد على هذه
الجوانب كمدخل لرصد المشهد اللغوي بالمغرب من جهة، والتعرف عليه عن كتب من جهة
أخرى، لفهم طبيعة الانعكاس التي تتحقق عند المتعلم، فمن خلال هذه الأدوار وغيرها، كانت اللغة ولا زالت موضوعا للدراسة والتفكير.
من هذا المنطلق نتساءل؛ ما المعجم؟ وكيف يمكننا اكساب المتعلمين معجم متين وغني؟ وماذا نقصد بالسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي؟ وما دور السلطة أو الجهات المسؤولة في تنمية اللغة وتطويرها؟ وما المعيقات التي تعوق دون تطور اللغة العربية؟ وماذا نقصد باللغة وما التنمية؟ وما هو دور اللغة في التنمية؟
وكيف تتدخل اللغة في تحقيق التنمية؟ وهل تشكل اللغة العربية عائقا أمام تحقيق تنمية شاملة بالمجتمعات الناطقة بها؟ وما هي الجهات التي بإمكانها أن تطور اللغة العربية وتجعلها أداة تنموية؟ وهل نستطيع إخضاع اللغة للمنطق الاقتصادي والنظر إليه كسلعة ذات قيمة تداولية؟ وما دور الإعلام في تنمية اللغة؟ وما تأثير العامية في عملية الاكتساب اللغوي؟
أهمية المعجم:
· - اللفظ والهجاء: من المعروف انه ليس كل ما يكتب ينطق، فكان على
المعاجم مهمة تقديم معلومات عما يكتب ولا ينطق، وتوضيح أي خطأ في نطق مفردة ما.
· - التحديد الصرفي: يقوم المعجم بتحديد نوع الكلمة: اسم، فعل، صفة...
والمذكر منها والمؤنث وتوضيح تعديها ولزومها وصورها الاشتقاقية وما إلى ذلك من أمور
الصرف.
· - الشرح: بيان معنى الكلمة وهي الوظيفة الأساسية لأي معجم، ويمكن أن يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى فيتم توضيح ذلك بأمثلة فعلية أو على الأقل بالإشارة إلى مجال استخدام المعاجم العربية[2].
كما أن الاحتكاك والتداخل مع اللغات الأخرى يولد مفردات جديدة لم تكن في أصل اللغة، ويكاد أن يكون هناك جزم بأنه لا توجد لغة حية الآن، إلا وقد استعارت مفردات من لغات أخرى.
- مفهوم المعجم:
يتحدد المفهوم اللغوي للفظة 'المعجم' في معجم لسان العرب باشتقاقه من مادة (ع ج م)، وهو: "خلاف العُرْب والعَرَبِ، والأعجم الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، والعجمي مبهم الكلام لا يتبين كلامه"[3]، والعجم بالهمزة تصبح (أعجم)، وهي إزالة الابهام والغموض بين حروف الكلام بإضافة النقط؛ أي "إزالة العجمة بالنقط" مثال ذلك: “ ب، ت، الذال، الضاد، الجيم والخاء".
فلفظة "المعجم" كما وردت في لسان العرب لم تكن بمعناها التام، اذ تم تداول لفظة "عجم" بمعنى: "غير العربي" و"الأعجم؛ العجمي" بمعنى: المبهم من الكلام، وأما لفظة "أعجم" كانت تعنى: بتجنب الخلط بين الحروف المتشابهة الرسم كـ:
- (دال والذال(الدال)،
- والحاء والخاء (الحاء)،
- والطاء والظاء(الطاء)،
- والعين، والغين (العين))،
بزيادة النقط على المعجمة منها. ولكن لفظة "المعجم" لم تكتسب دلالتها الحديثة إلا بعد مرورها بمراحل تكوينية ساهمت في تطورها وتبلور طبيعتها الاستعمالية والمفاهيمية.
إذ تعنى في الاصطلاح بـ "مرجع يشتمل على مفردات لغة ما مرتبة عادة ترتيبا هجائيا، مع تعريف كل منها وذكر معلومات عنها من صيغ ونطق واشتقاق ومعان واستعمالات مختلفة. مثال ذلك: "المعجم الوسيط" لجمع اللغة العربية بالقاهرة".[4]
وكذلك بـ "كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها، على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف الهجاء أو الموضوع، والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع استعمالها"[5].
وعليه فالمعجم بمفهومه الحديث يعنى بكل مرجع يشمل مجموعة من المفردات المنتمية
للغة موحدة معيارية ما والمرتبة ترتيبا يخصه صاحب المعجم بالعناية إما بحسب حروف
الجاء أو الموضوع، وذلك بهدف تسهيل تصفح المعجم وإيجاد المفردة الذي يبتغى الاطلاع
لشرحها بحسب المعنى والاشتقاق وطريقة النطق الرصينة مع تنويع شواهد موضحة لسبل
استعمالها السليم في مواضع الخطاب.
- أنواع المعجم :
تتعدد أنواع المعاجم بحسب تعدد وظائفها العلمية والمعرفية، باعتبار أن الباحث في اللغة العربية لابد له من البحث في المعاجم بالشكل الصحيح، وهذا لا يتحقق إلا بالإحاطة بمدارس المعجم وتعرف الطرق ومناهج الاشتغال به.
ومن منا لا يعلم أن "الخليل بن احمد الفراهيدي" أنشأ لمعجمه منهجا ترتيبيا يقوم على "الترتيب الصوتي وفقا لمخارج الحروف من أقصى الحلق إلى ظاهر الشفتين"، "مخالفا بذلك الترتيب المشرقي ترتيب 'نصر الدين بن عاصم' لحروف الهجاء العربية[6]؛"أ-ب-ت-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ط-ظ-ك-ر-م-ن-ص-ض-ع-غ-ف-ق-س-ش-ه-و-ي".
وتوالت جهود العرب بعد ذلك في تأليف المعاجم الجديد للتنوع بذلك المعاجم ووظائفها وتتكون مجموعة من المعاجم.
- المعجم المدرسي:
إن مستوى الاكتساب اللغوي عند المتعلم المغربي خصوصا في مراحله الأولى: مرحلة التعليم الابتدائي، ومرحلة التعليم الإعدادي، يضعنا أمام ضرورة الحديث عن معجم مدرسي يساعد المتعلمات والمتعلمين على تنمية الكفايات اللغوية وتطويرها.
لكن هذه العملية تشوبها العديد من الإشكالات التي تجعل المعجم المدرسي يفتقد إلى مداخل ودعامات تعززه، وتزود المتعلم باليات التعبير. والمعجم المدرسي بهذا المعنى هو "مجموع الوحدات المعجمية المتداولة فعليا في الكتب المدرسية في كل مستوى معين وضمن السياق العليمي لهذه الكتب"[1].
ويفلح المعجم المدرسي في مساعدة متكلمي اللغة العربية إلى العودة له، بها بشكل سليم يسهل الاستعمال اللفظي العربي الرصين؛ باستبدال لفظة عامية مغربية بلفظة أخرى عربية، أو بإفهام لغوي لمستغلق لفظي تمت مصادفته في أحد السياقات التواصلية فينتج عن ذلك فعل التعلم،
ولهذا السبب وجد "المعجم المدرسي" لتحقيق الأهداف التعليمية التعلمية المتوخاة في درس اللغة العربية المستنجد بمعاجم مكوناته ومجالاته المتنوعة المحققة للكفاية التواصلية المتمثلة في:
- "إتقان اللغة العربية، والتمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها في مختلف مجالات تعلم المواد الدراسية، ثم التمكن من مختلف أنواع الخطاب (الأدبي، العلمي، والفني...) المتداولة في المؤسسة التعليمية وفي محيط المجتمع والبيئة"[2].
ومن هنا نفهم أن المعاجم المدرسية هي تدليلات لمعاجم لغوية قديمة أخد منها المفيد المستعمل في مستوى معين وسياق تعليمي يخص خصوصيات الكتاب المدرسي الذي قدم معه معجمه الخاص به ليتزود به المتعلم أثناء الحاجة إلى سقل عربيته الفصحى أثناء فعله التواصلي التفاعلي كان داخل الصف الدراسي 'كتابيا أو شفهيا' أو خارجه،
وفي هذا السياق لا ضير من ذكر لمحة تاريخية عن أول
معجم مدرسي قام بتذليل المعجمات القديمة وهو "مختار الصحاح للرازي (ت
666هـ)" إذ يقول في مقدمته متحدثا عن طبيعة عمله المختصر لـ"معجم الصحاح
للجوهري (تـ393هـ)": "اجتنبت فيه عويص اللغة، وغريبها، طلبا للاختصار،
تسهيلا للحفظ"[3].
وهذا ما يحيلنا مباشرة إلى أن المعجم المدرسي يتسم بملمح الوظيفية في جعله أداة يوظفها المتعلم في الفهم والوقوف على المعاني وشرح المفردات ضمن سياقها الخاص، ويشير هذا إلى:
" ارتباط المعجم المدرسي بالمدرسة وبالمنهاج الذي يدرس في مستوى معين يدعو إلى أن يعكس هذا المعجم المضامين الواردة في المنهاج التي يتعرض المتعلم إلى حاجة البحث فيها لاستجلاء ما غمض منها أو للاستزادة وإغناء رصيده منها"[4].
المعجم الذهني:
تروم الدراسات المعجمية البحث في القدرة المعجمية عند المتكلم وما توفره من إمكانات تساعده على الاسترجاع السريع للمفردات المخزنة في ذهنه، والتي يحتاجها للتعبير باللغة في سياق يستدعي ذلك.
فعندما نتحدث عن المعجم الذهني
فإننا نتحدث عن الملكة الفطرية عند المتعلم لا عن المعاجم الورقية التي تحتاج من
الباحث وقتا كبيرا وجهدا للعودة إليها والبحث فيها، هذا لا يعني أن ذهن الإنسان
يعود إلى المفردات المخزنة بشكل ميكانيكي، بل الهدف من هذه العملية هو إنتاج وتوليد
معان جديدة لم تدرج سمعه قبلا.
وقد أشار (ب ريختر G.P. RIrichter) إلى أن الطفل "عن طريق بعض العناصر القليلة والمرنة جدا يستطيع أن يصوغ أكثر التكوينات تنوعا من الألفاظ والمعاني"[5].
فالكائن البشري مزود بقواعد فطرية قبلية تهيؤه لاكتساب اللغة وتوليدها، من خلال
تصميمه البيولوجي الذي يمكنه من الجري والسباحة مثلا، ولا يمكنه من الطيران، متسما
بخاصية الإبداعية (Creativity) في اللغة، كما ذهب إليها الاتجاه التوليدي مع
اللساني الأمريكي (نعوم أفرام تشومسكي).
وإذا ربطنا المعجم الذهني بالمجال التربوي، فإن ما يهمنا ليس هو الكشف عن النظام الذي يشتغل به هذا المعجم، بل البحث عن سبل تنمية الملكة المعجمية التي يتوفر عليها المتعلم، حيث أشار (دالر Daller) 2007، "أن عملية تعلم المفردات تتطور بشكل تصاعدي من خلال الاستعمال اليومي للغة في سياقات ووضعيات مختلفة"[6].
والتي تمكنه من التعبير باللغة شفويا وكتابيا وتخزينها، والعودة إليها بشكل سريع وآني، وفق نظام معين يمكنه من استثمار هذه الملكة بالشكل الأمثل في ضبط اللغة والإحاطة بقدر كبير منها مما يمكنه من معالجة ضعف الرصيد المعجمي لديه الذي يغنيه عن استعمال العامية في انتاجاته الصفية، إذ يكون المتعلم مطالبا فيها بالتواصل شفويا وكتابيا باللغة العربية الفصحى معجما وأسلوبا.
خاتمة:
ومن التجليات التي يظهر فيها الفراغ المعجمي في مكون التعبير والإنشاء، الذي يعرف حسب الملاحظة الميدانية للوسط التربوي استعمال أو توظيف عدد من المتعلمين عن غير قصد المعجم العامي في خطابه.
حيث "يتفق كل من سنكلتون وبافلنكو
2009 singlton
and pavlendko مع الافتراض الذي يقول إن هناك تداخل وتقاطع
لغوي بين معجم اللغة الأم واللغة موضوع التعلم، وأن بعض المجالات مشتركة بينهم" [7]، نظرا لعدد من العوامل المتداخلة في انتشار
هذه الظاهرة داخل الوسط التعليمي المغربي.
[2] البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بمادة اللغة العربية بسلك التعليم
الثانوي، مديرية المناهج والحياة المدرسية، ملحقة للاعائشة، شارع شالة، حسان،
الرباط، غشت 2009، ص:6-7.
[3]
أبوبكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، السنة: 1995، المقدمة.
[4] عباس الصوري:
بحوث
ودراسات لغوية ومعجمية: في الممارسة المعجمية للمتن اللغوي، مجلة اللسان العربي،
العدد: الخامس والأربعون (45)، مكتبة تنسيق التعريب، الرباط، المغرب، التاريخ: 01
يناير 1889م، ص: 27.
[5] سيرجيو سبينى: التربية
اللغوية للطفل. تـ، فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن، دار الفكر العربي. ص:9(بتصرف).
[6] أحمد
بريسول، دراسات في الدلالة والذريعيات، ص:33.
[7] المرجع
نفسه، ص :21.
[2] موقع الموسوعة المعرفية الشاملة باللغة
العربية (تمت الزيارة بتاريخ 23/06/2023؛ على الساعة 3:00 صباحا).
[3] ابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، الجزء 46، دار صادر
بيروت، الصفحة: 2826
[4]
مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العرية في اللغة
والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، السنة: 1984، الطبعة الثانية، ص: 284-285.
[5]
المرجع نفسه، ص: 9.
[6] المرجع السابق،
ص:39، (بتصرف).
[7] نفسه، ص:15-16 17-18، (بتصرف).